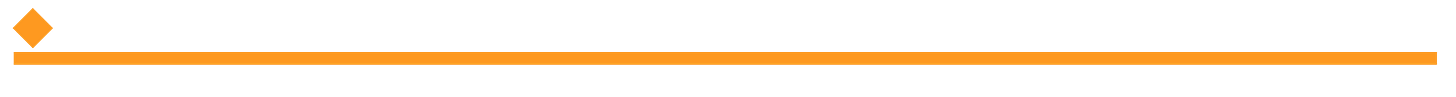نشرة الزاد | العدد 5
أهلاً بكم في العدد الخامس من نشرة "الزّاد" التي تصدر عن الشبكة العربية للعلوم السياسية.
نهدف في كل عدد إلى انتقاء مجموعة من الأبحاث والمقالات الأكاديمية الصادرة حديثاً باللغة العربية أو الإنجليزية، والتي نتناول فيها مواضيع بحثية متنوعة عن ومن العالم العربي ومحيطه الجغرافي. تقوم النشرة على تقديم وتسهيل الوصول إلى محتوى بحثي وأكاديمي ومشاركته مع جمهور أوسع من المهتمات والمهتمين بحقل الدراسات السياسية والعلوم الاجتماعية.
نقدم في كل نشرة ملخصات لبعض من المقالات الأكاديمية التي نشرت في مجلات محكّمة، مع ترجمة للغة العربية لما صدر باللغة الإنجليزية وإضافة روابط المقالات من مصدرها. نتطلع إلى أن تُسهم هذه النشرة والمقالات المنتقاه في فتح نوافذ متسعة للبحث والنقاش المعرفي والأكاديمي.
*تنويه: تستقي النشرة النصوص التعريفية المرفقة لكل مقالة بشكلٍ مباشرة من المجلة التي أصدرتها، مع الحفاظ على جميع حقوق المؤلف والناشر والمجلة. يقتصر دور فريقنا على نقل وترجمة النصوص وعرضها دون تعديل أو إضافة.
تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في بناء الرأي العام تجاه حرب غزة
منية بن عياد
كلمات مفتاحية: المؤثرون، الرأي العام، القضية الفلسطينية، طوفان الأقصى، حرب غزة
"تهدف الدراسة إلى التعرف بماهية مؤثري التواصل الاجتماعي كقوة جديدة في البيئة الاتصالية ودورهم في بناء الرأي العام العالمي نحو حرب غزة وتأثيرهم في مجريات الأحداث، إضافة إلى الكشف عن التحديات التي تعرضوا لها في إيصالهم رسائلهم."
Ruth Hanau Santini
كلمات مفتاحية: الأمننة، نزع الأمننة، الشرق الأوسط، سياسات الخليج، تمثيلات الفضاء
لقد شكّلت عمليتا "الأمننة" و"نزع الأمننة" – مؤخرًا – الفضاء الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من أمثلة الأمننة في العقدين الأول والثاني من الألفية الثالثة السياسات القسرية التي تبنتها المملكتان السعودية والإماراتية ضد كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعراق، واليمن، وقطر، استنادًا إلى منطق طائفي (مناهضة النفوذ الشيعي) أو أيديولوجي (مناهضة الإسلام السياسي). في النظام الإقليمي الذي تلا عام 2020، مهّدت التحولات في التصورات الإقليمية وتقديرات التهديد لدى هذه الأنظمة الطريق أمام اتفاقات دبلوماسية جديدة أسهمت في نزع الأمننة إقليميًا. وبالاعتماد على نظرية المجمعات الأمنية الإقليمية، ومقاربات الاقتصاد السياسي الليبرالي الدولي، توضح هذه التحولات السياسية والمكانية من خلال تتبع العمليات وتحليل وثائق استراتيجية رئيسية صادرة عن المملكتين السعودية والإماراتية. يشير التحليل إلى أن التوقعات بتبادلات تجارية إيجابية قد خفّضت من احتمالية النزاع، وشكّلت دافعًا إضافيًا لتعزيز الروابط التجارية كأداة لتحقيق الاستقرار. ورغم أن تقلبات المنطقة قد تصاعدت على ما يبدو منذ حرب غزة 2023–2024، ما أدى إلى انتشار النزاع وظهور عمليات أمننة جديدة وسياسات مكانية إقصائية، فإن هذه التطورات لا تلغي العمليات المتوازية للسياسات المكانية القائمة على العلاقات ونزع الأمننة التي بدأت بها الممالك السنية الخليجية منذ أواخر العقد الثاني من الألفية.
السياسة الخارجية السعودية تجاه التدخل الإيراني و التركي في العراق خلال الفترة من 2003 - 2021
مروة كامل محمد عبدالجيد
كلمات مفتاحية: السياسة الخارجية، السعودية، العراق، إيران، تركيا
"يعد موضوع السياسة الخارجية السعودية تجاه التدخل الإيراني والتركي في العراق بعد الإحتلال الأمريكي عام 2003م وحتى عام 2021م موضوعاً مهماً يستدعي دراسته. نظراً لما شهده العراق من تغير في أنظمة الحكم، بالإضافة إلى تدخل الدول في شؤونه الداخلية، الأمر الذي أثر على السياسة الخارجية السعودية الموجهة تجاهه، حيث أصبح العراق ساحة للتنافس بين القوى الإقليمية وبخاصة إيران وتركيا، تم استخدام منهج صنع القرار في هذه الدراسة، وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور يتناول الأول منهما: مؤسسات صنع القرار في السياسة الخارجية السعودية، ويوضح المحور الثاني: أهمية العراق في الإستراتيجية السعودية، بينما يحلل الثالث: موقف السعودية من التدخل الإيراني في العراق خلال الفترة من 2003_2021م، ويتناول المحور الرابع: موقف السعودية من التدخل التركي في العراق خلال الفترة من 2003_2021م، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: إن الإحتلال الأمريكي للعراق جعل منه ساحة لتصفية الحسابات، وإن السياسة الخارجية السعودية تجاه العراق بعد الإحتلال الأمريكي اتسمت بعدم الإستقرار حتى عام 2014م ولكن منذ ذلك العام وحتى عام 2021م شهدت العلاقات السعودية العراقية تحسناً ملحوظاً، ورفضت السعودية التدخل الإيراني في العراق، بينما تبنت موقف ساكناً تجاه التدخل التركي في العراق."
Wolfram Lacher
كلمات مفتاحية: الحركات الإسلامية المتطرفة، ليبيا، التعبئة المسلحة، الجهادية، التغيرات الاجتماعية، النزاعات المسلحة، فهم الصراعات
تعجز المقاربات السائدة في فهم التعبئة الإسلامية عن تفسير السبب وراء الانتشار السريع للحركات الإسلامية المتطرفة في ليبيا بعد عام 2011، ثم اختفائها المفاجئ شبه الكامل بعد ذلك بوقت قصير. يُشكّل هذا التراجع لغزًا في مواجهة التحليلات التقليدية. لقد ساهمت الخيارات التكتيكية، مثل البحث عن الحماية أو الحلفاء، في كلٍ من صعود الحركات الإسلامية المتطرفة وانحدارها. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات التكتيكية لم تكن بمعزل عن العوامل الاجتماعية، بل تأثرت بعلاقات الثقة التي كانت تحتفظ بها تلك الجماعات، ومدى القبول الاجتماعي الذي حظيت به. يمكن فهم الازدهار القصير الأجل للحركات الإسلامية المتطرفة، جزئيًا، كظاهرة "موضة" اجتماعية؛ حيث سعى الفاعلون إلى التمايز الاجتماعي أو التوافق مع محيطهم من خلال تبنيهم السطحي للخطاب الإسلامي ومظاهره الجمالية، قبل أن يتخلوا عنها لاحقًا. إن تحليل التراجع الدراماتيكي لهذه الحركات يساهم في فهم أعمق للدوافع المتعددة التي كانت خلف صعودها. لقد تم التغاضي حتى الآن عن "الاعتراف الاجتماعي" كدافع أساسي وراء التعبئة المسلحة. تُظهر الحالة الليبية أن استخدام تصنيفات مثل "إسلاميين" و"جهاديين" يجب أن يتم بحذر بالغ، خاصةً في سياقات النزاعات المستمرة. فأولاً على الجهات الخارجية أن تعي أن أطراف النزاع توظف هذه التصنيفات بشكل متعمد ومغلوط، وثانيًا أن تطور فهمًا دقيقًا للبيئة الاجتماعية التي تنشط فيها الحركات الإسلامية المتطرفة.
تأثير الأيباك في الطريق إلى البيت الأبيض
محمد مشيك وعادل خليفة
كلمات مفتاحية: الثنائية الحزبية، المجمع الانتخابيّ، اللوبي، أيباك، حريّة الرأي والتعبير
"ترى هذه الدراسة أنّه نظرًا إلى أنّ السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية تتأثّر بمؤثرات رسمية وغير رسمية، ولأنّ الولايات المتحدة الأمريكية دولة ليبرالية، فإنّ الفاعلين غير الرسميين، مثل جماعات الضغط التي تتمتّع بنفوذ وسلطة على صانعي القرار والسياسة الأمريكية، يؤدون دورًا رئيسًا في التأثير في السياسة العامة.
وتعدّ لجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية (أيباك)، من أهمّ جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتّع بنفوذ قويّ لدى صانعي السياسة العامة الأمريكية. كما تعَدّ أيباك (AIPAC) من أبرز المنظمات المعنية بقضايا الصهيونية العالمية، وتسعى إلى جعل السياسة الأمريكية متوافقة مع المصالح الإسرائيلية، في ظلّ ثورة الطلاب الأمريكيين في أهمّ الجامعات من أجل وقف الإبادة الجَماعيّة في قطاع غزّة، وما تبع هذه الثورة من انتهاك لحريّة الرأي والتعبير التي يتغنّى بها الغرب."
Smaller Gulf states and competing geopolitical scripts in the Indo-Pacific
Máté Szalai
كلمات مفتاحية: دول الخليج الصغيرة، الجغرافيا السياسية، مبادرة الحزام والطريق، المنافسة بين القوى الكبرى، القوة المحورية، السياسة الإقليمية
نظرًا للأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، قامت القوى الكبرى بصياغة عدد من السيناريوهات الجيوسياسية لتشكيل ديناميكيات المنطقة. وغالبًا ما يُهمَّش منظور الأطراف الأصغر، مثل الممالك الخليجية الصغيرة (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة) أو يُبَسَّط، رغم امتلاكها لرؤى خاصة تجاه هذه المنطقة. ويسعى هذا المقال إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليل كيف تنظر الدول الخليجية الصغيرة إلى التنافس المتصاعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بين اثنين من أبرز الأطر الجيوسياسية التي تطرحها القوى الكبرى، وهما: مبادرة الحزام والطريق ومفهوم المحيطين الهندي والهادئ الحر والمفتوح. يجادل المقال من خلال تحليل هذين الإطارين من منظور دول الخليج الصغيرة، بأن مصالح هذه الدول تتمحور حول تعظيم قوتها المحورية، وهو ما يستلزم إعطاء الأولوية لأمن الملاحة البحرية والتنمية الاقتصادية في الوقت ذاته، والانخراط المتوازي في صيغ تعاون ثنائية، ومصغرة، ومتعددة الأطراف.