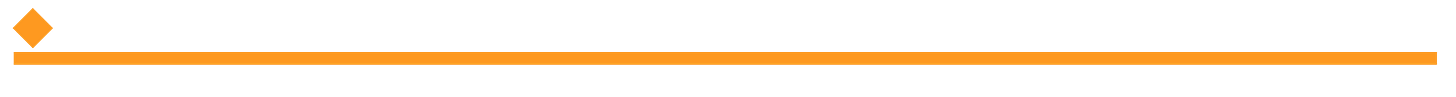نشرة الزاد | العدد 6
أهلاً بكم في العدد السادس من نشرة "الزّاد" التي تصدر عن الشبكة العربية للعلوم السياسية.
نهدف في كل عدد إلى انتقاء مجموعة من الأبحاث والمقالات الأكاديمية الصادرة حديثاً باللغة العربية أو الإنجليزية، والتي نتناول فيها مواضيع بحثية متنوعة عن ومن العالم العربي ومحيطه الجغرافي. تقوم النشرة على تقديم وتسهيل الوصول إلى محتوى بحثي وأكاديمي ومشاركته مع جمهور أوسع من المهتمات والمهتمين بحقل الدراسات السياسية والعلوم الاجتماعية.
نقدم في كل نشرة ملخصات لبعض من المقالات الأكاديمية التي نشرت في مجلات محكّمة، مع ترجمة للغة العربية لما صدر باللغة الإنجليزية وإضافة روابط المقالات من مصدرها. نتطلع إلى أن تُسهم هذه النشرة والمقالات المنتقاه في فتح نوافذ متسعة للبحث والنقاش المعرفي والأكاديمي.
*تنويه: تستقي النشرة النصوص التعريفية المرفقة لكل مقالة بشكلٍ مباشرة من المجلة التي أصدرتها، مع الحفاظ على جميع حقوق المؤلف والناشر والمجلة. يقتصر دور فريقنا على نقل وترجمة النصوص وعرضها دون تعديل أو إضافة.
سياسة إسرائيل تجاه المشروع النووي الإيراني في بداية حكم الرئيس إبراهيم رئيسي
محمود محارب
كلمات مفتاحية: إسرائيل، إيران، البرنامج النووي الإيراني
"تتلخص فرضية هذه الدراسة الأساسية في سعي إسرائيل الدائم للحفاظ على احتكارها الساح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وقيامها بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، من كسر احتكار إسرائيل السلاح النووي في المنطقة. تتابع الدراسة سياسة إسرائيل التي تدعو إلى فرض أقصى العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، التي تقود إلى تخليها كليًّا عن السلاح النووي أو إلى إسقاط النظام الإيراني. وتعرض سياسة إسرائيل تجاه مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وتقف على الارتباك الاستراتيجي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه، من جراء العديد من الفرضيات المخطئة التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المشروع النووي الإيراني، وتعرض أهداف إسرائيل من "المعركة بين الحروب" التي تشنها ضد إيران، وتقف على الاستراتيجية الكبرى ضد إيران التي ينادي بها منظرو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وتتابع سعي إسرائيل لإقامة حلف عسكري إسرائيلي - عربي - أميركي ضد إيران، وتعرض التصور الإسرائيلي للهجوم العسكري الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية والمخاطر والمشكلات التي تواجهه."
Staying safe by being good? The EU’s normative decline as a security actor in the Middle East
Erik Skare
كلمات مفتاحية: الاتحاد الأوروبي، مكافحة الإرهاب/منع التطرف العنيف، القوة المعيارية، الإرهاب، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التسييس الأمني
حظيت جهود الاتحاد الأوروبي في التعاون مع أنظمة الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف باهتمام أكاديمي متزايد، خاصة بعد عدة هجمات إرهابية شهدتها أوروبا خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من تركيز الاتحاد الأوروبي على مبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية وحقوق الإنسان كوسائل لمنع التطرف العنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يُجادل بأن الاتحاد الأوروبي يشهد تراجعًا كـ "قوة معيارية" (Normative Power) نتيجة تبنيه نهجًا يركز على "الأمن أولًا".
تُظهر هذه المقالة كيف أن مشاريع الاتحاد المعيارية قد: أولًا، تبنت منطق التسييس الأمني (securitisation)؛ وثانيًا، كيف يقلل الاتحاد من أهمية الديمقراطية والحوكمة الجيدة خشية إبعاد شركائه السلطويين الرئيسيين في المنطقة. وبالتالي، هناك حدود داخلية وتناقضات جوهرية في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
تعتمد هذه الاستنتاجات على مقابلات أُجريت مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وشركاء منفذين على الأرض، بالإضافة إلى تحليل لنطاق وتركيز مشاريع الاتحاد في مجالي مكافحة الإرهاب ومنع التطرف. وتشير النتائج إلى وجود دلالات أوسع لفهم أولويات القوى المعيارية عند مواجهة معضلة يُنظر إليها كمفاضلة بين الأمن من جهة، والهوية والطموحات القيمية من جهة أخرى.
التقانات الحديثة والحروب غير المتناظرة
يونس بعلوشة وإبراهيم ربايعة
كلمات مفتاحية: الحروب غير المتناظرة، الحرب على غزة 2023، التحولات العسكرية الحديثة، الطائرات المسيّرة (UAVs)، الذكاء الاصطناعي العسكري، الأسلحة الموجّهة، الحرب السيبرانية
"تطورت التقانات المستخدَمة في الحروب بصورة متسارعة، وهو ما أتاح للدول تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم على نحو نسبي. منذ استخدام الحجارة كأدوات بدائية في القتال، وحتى الوصول إلى التقانة المتقدمة والذكاء الاصطناعي اللذين يمثلان اليوم محور اهتمام البحث والتصنيع العسكري على المستوى الدولي[1]، تسعى الدول إلى تطوير هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق التفوُّق العسكري بصورة أكثر فعالية وسرعة. على مدى العقدين الأخيرين، أُنتجت مجموعة من التقانات العسكرية التي تستغل البيئة المحيطة للوصول إلى أداء وكفاءة أعلى. تشمل هذه التقانات الأنظمةَ السيبرانية، والروبوتات، والمسيَّرات. تمثل هذه التطوّرات تهديدًا كبيرًا للجيوش التقليدية، والمجموعات غير النظامية على حد سواء، إذ جعلت من التدريبات الحالية والمعدَّات والعقائد وسائل منقوصة في المواجهة في حال عدم اللجوء إلى استغلال التطور التقاني. تواجه الجيوش اليوم تحديًا أساسيًا يتمثل بالقدرة على التكيُّف مع التقانات الناشئة، حيث تتطلب القدرة على الاندماج بين التقانة والقدرات العسكرية لتعزيز المرونة والأداء وتقليل الزمن اللازم للرد على التهديدات. تبدأ هذه الجهود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تُستخدم في جمع المعلومات من المصادر المفتوحة والخاصة لتحليل الظواهر والتفاعل معها وفقًا للمعطيات المبرمجة."
?AI on the Battlefield: A Fait Accompli
كلمات مفتاحية: الذكاء الاصطناعي (AI)، وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (DARPA)، الطائرات بدون طيار، الاستخبارات، قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، الاستطلاع، أوكرانيا، صور الأقمار الصناعية، ستورم كلاود (Stormcloud)
يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) اليوم أن يوفر رؤى وقدرات ذاتية ودعمًا لاتخاذ القرار لقادة ساحات المعركة. ومع ذلك، يزداد صعوبة التمييز بين اقتراحات الذكاء الاصطناعي وقراراته – وبين فهم البيانات واتخاذ الإجراءات بناءً عليها. ومع تطور أنظمة دعم القرار، يصبح من الأصعب فهم أسس توصياتها أو مجاراة سرعتها ونطاق عملها، وبالتالي يصعب الحفاظ على سيطرة بشرية ذات مغزى. والمفارقة الناشئة هي أنه حتى مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم صورة أوضح لساحة المعركة، فإن مخاطر الحرب أصبحت أكثر غموضًا للمقاتلين. ومع ازدياد النظر إلى أحكام النماذج على أنها تشبه النبوءات، سيصبح من الأصعب تقييم مخرجاتها دون التنازل للعدو عن ميزة فتاكة. سواء كانت الأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مفيدة أم خطرة في المجمل، فإن الوقائع على الأرض قد تجعل هذا الجدل بلا جدوى.
النزاع العراقي - السوري - التركي على مياه دجلة والفرات: قراءة جيوبوليتيكية
عبدالكريم داود
كلمات مفتاحية: العراق، سوريا، تركيا، الفرات، دجلة
"تهتم الدراسة بدراسة واحد من عناصر المسألة المائية في الشرق الأوسط، يتمثل في النزاع العراقي - السوري - التركي حول مياه دجلة والفرات، من زاوية جيوبوليتيكية، وتنطلق من فرضية أساسية تقول إنّّ لهذا الصراع جذورًًا تاريخية وسياسيّّة، ولا يرتبط بحجم ما يتوافر طبيعيًّا من مياه في دجلة والفرات بقدر ارتباطه بتباين سياسات مختلف الأطراف في إدارة الموارد المائية. وتضمنت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية. اهتمّ الأوّل بالنظر في الخصائص الجغرافيّّة والهيدرولوجيّّة لدجلة والفرات. وخُُصّّص العنصر الثاني للبحث في ما راج في الأوساط السياسية والأكاديمية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي حول نظرية "حرب المياه". أمّّا العنصر الثالث والأخير، فقد طمح إلى تحليل خصائص الوضعية الجديدة التي ميّّزت الدول الثلاث منذ مطلع هذا القرن، والتي تفرض على سورية والعراق استنباط رؤية جديدة لإدارة مواردهما المائية المتاحة. وتخلص الدراسة إلى حتمية التفاوض لإدارة الموارد المائية المشتركة لدجلة والفرات، لأنّّه ليس من مصلحة تركيا تجاهل مصالح دول المصبّّ، ثم إنّّه ليس في قدرة سورية والعراق تحقيق أي نتائج دون التفاوض ودون الدبلوماسية المائية."
Carl Rommel
كلمات مفتاحية: كرة القدم، الطبقة الاجتماعية، مصر، إدارة الدولة، الثورة
تتناول هذه المقالة بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 (AFCON) التي أُقيمت في مصر كمحاولة طموحة، لكنها فشلت في نهاية المطاف، لعرض حالة جديدة من "الأجواء الطبيعية" ما بعد الثورة. في الأشهر التي سبقت البطولة، أنفقت الحكومة المصرية موارد ضخمة على تجديد الملاعب، وتعزيز الأمن، وتقديم نظام تذاكر إلكتروني متطور. وقد صُورت البطولة في وسائل الإعلام على أنها دليل على نهاية ثماني سنوات من الاضطرابات الثورية.
ومع ذلك، بالنسبة للمحاوَرِيَّ – رجال من الطبقة المتوسطة في القاهرة كانوا من مشجعي كرة القدم المخلصين قبل ثورة 2011 – لم تبدُ الرياضة وكأنها عادت إلى طبيعتها. فقد بدا الجو في الملاعب مصطنعًا وكئيبًا، و"المشجعون الحقيقيون" لم يحضروا، ولم يتمكن المنتخب الوطني من إشعال الحماسة.
تضع المقالة هذا الالتباس في سياقه التاريخي والاجتماعي من خلال العمل الإثنوغرافي وتحليل وسائل الإعلام. وتُظهر كيف كانت البطولة مشحونة بالدلالات القوية لكرة القدم المرتبطة بـ"الأجواء الطبيعية" قبل عام 2011، وكيف أدت إلى بروز توترات بين رؤى مختلفة – بحسب الطبقة الاجتماعية – حول الرياضة، والرجولة، والهوية الوطنية. ويسلط الانتباه إلى هذه التوترات الضوء ليس فقط على البنية الاجتماعية والجمالية التي يستند إليها نظام السيسي، بل يكشف أيضًا عن سبب تعثر محاولات ترسيخ "طبيعية" ما بعد الثورة في مصر، طبيعية تبدو وتشعر بأنها طبيعية بالفعل لجميع فئات المجتمع.